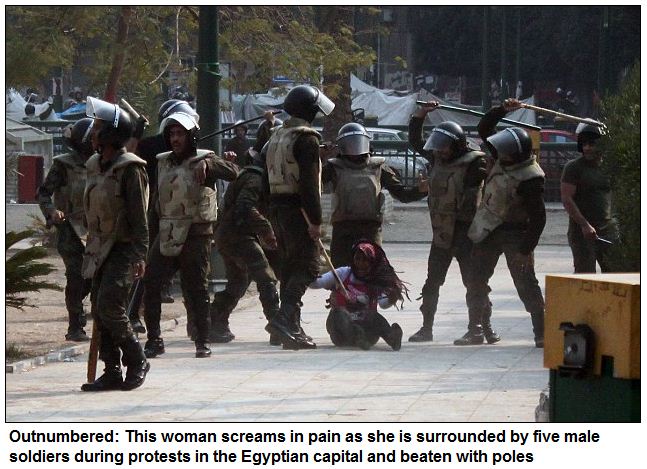الجزء الثاني >> تتمَّة كتاب الإيمان >> -25- باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطَّاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باللَّه، ككفر النِّعمة والحقوق
1- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:
عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- أَنَّهُ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاستغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ".
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟
قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ".
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟
قَالَ: "أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ".
--------------------------------------------
قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاستغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةُ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟
قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ.
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟
قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).
قال أهل اللُّغة: المعشر هم الجماعة الَّذين أمرهم واحد أي: مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر، والجنُّ معشر، والأنبياء معشر، والنِّساء معشر ونحو ذلك، وجمعه: معاشر.
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) وهو بنصب أكثر، إمَّا على أنَّ هذه الرُّؤية تتعدَّى إلى مفعولين، وإمَّا على الحال على مذهب ابن السَّرَّاج وأبي عليٍّ الفارسيِّ وغيرهما ممَّن قال: إنَّ أفعل لا يتعرَّف بالإضافة.
وقيل: هو بدل من الكاف في رأيتكنَّ.
وأمَّا قولها: (وَمَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) فمنصوب إمَّا على الحكاية، وإمَّا على الحال.
وقوله: (جَزْلَةٌ) بفتح الجيم وإسكان الزَّاي، أي: ذات عقل ورأي.
قال ابن دريد: الجزالة: العقل والوقار.
وأمَّا العشير، فبفتح العين وكسر الشِّين، وهو في الأصل المعاشر مطلقاً، والمراد هنا: الزَّوج، وأمَّا اللُّبّ: فهو العقل والمراد: كمال العقل.
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (فَهَذَا نُقْصَانُ العَقْلِ) أي: علامة نقصانه.
وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي) أي: تمكث ليالي وأيَّاماً لا تصلِّي بسبب الحيض، وتفطر أيَّاماً من رمضان بسبب الحيض، واللَّه أعلم.
وأمَّا أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها: الحثُّ على الصَّدقة وأفعال البرِّ والإكثار من الاستغفار وسائر الطَّاعات.
وفيه: أنَّ الحسنات يذهبن السَّيِّئات كما قال الله عز وجل.
وفيه: أنَّ كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإنَّ التَّوعُّد بالنَّار من علامة كون المعصية كبيرة، كما سنوضحه قريباً إن شاء الله تعالى. (ج/ص: 2/67)
2- وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.
3- وَحَدَّثَني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللَّه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْروٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :
--------------------------------------------
وفيه: أنَّ اللَّعن أيضاً من المعاصي الشَّديدة القبح، وليس فيه أنَّه كبيرة، فإنَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- قال: "تُكْثِرْنَ اللَّعَنَ" والصَّغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة، وقد قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: "لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ".
واتَّفق العلماء على تحريم اللَّعن، فإنَّه في اللُّغة: الإبعاد والطَّرد، وفي الشَّرع: الإبعاد من رحمة اللَّه، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعيَّة، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابَّة إلاَّ من علمنا بنصٍّ شرعيٍّ أنَّه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس.
وأمَّا اللَّعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، والمصوِّرين والظَّالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غيَّر منار الأرض، ومن تولَّى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثاً أو آوى محدثاً، وغير ذلك ممَّا جاءت به النُّصوص الشَّرعيَّة بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيان، واللهُ أعلم.
وفيه: إطلاق الكفر على غير الكفر باللَّه، ككفر العشير والإحسان والنِّعمة والحقِّ، ويؤخذ من ذلك صحَّة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدِّمة على ما تأوَّلناها.
وفيه: بيان زيادة الإيمان ونقصانه.
وفيه: وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء النَّاس رعاياهم، وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطَّاعات.
وفيه: مراجعة المتعلِّم العالم والتَّابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزلة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-.
وفيه: جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشَّهر وإن كان الاختيار إضافته، واللَّه أعلم.
قال الإمام أبو عبد الله المازريُّ -رحمه اللَّه-: قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (أَمَّا نُقْصَانُ العَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ) تنبيه منه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- على ما وراءه، وهو ما نبَّه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282] أي: أنَّهنَّ قليلات الضَّبط.
قال: وقد اختلف النَّاس في العقل ما هو؟
فقيل: هو العلم.
وقيل: بعض العلوم الضَّروريَّة.
وقيل: قوَّة يميِّز بها بين حقائق المعلومات، هذا كلامه.
قلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في محلِّه.
فقال أصحابنا المتكلِّمون: هو في القلب.
وقال بعض العلماء: هو في الرَّأس، واللَّه أعلم. (ج/ص: 2/68)
عَنْ النّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-.
--------------------------------------------
وأمَّا وصفه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- النِّساء بنقصان الدِّين لتركهنَّ الصَّلاة والصَّوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإنَّ الدِّين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدَّمناه في مواضع، وقد قدَّمنا أيضاً في مواضع أنَّ الطَّاعات تسمَّى إيماناً وديناً، وإذا ثبت هذا علمنا أنَّ من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه.
ثمَّ نَقْصُ الدِّين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصَّلاة أو الصَّوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصَّلاة أو الصَّوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك ممَّا لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلَّف به، كترك الحائض الصَّلاة والصَّوم.
فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصَّلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصَّلوات الَّتي كان يفعلها في صحَّته وحضره؟
فالجواب أنَّ ظاهر هذا الحديث أنَّها لا تثاب، والفرق أنَّ المريض والمسافر كان يفعلها بنيَّة الدَّوام عليها مع أهليَّته لها، والحائض ليست كذلك بل نيَّتها ترك الصَّلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نيَّة الصَّلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلِّي النَّافلة في وقت ويترك في وقت غير ناوٍ الدَّوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزَّمن الَّذي لم يكن يتنفَّل فيه، واللَّه أعلم.
وأمَّا ما يتعلَّق بأسانيد الباب ففيه: ابن الهاد، واسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة، وأسامة هو الهاد لأنَّه كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطَّريق، وهكذا يقوله المحدِّثون: الهاد وهو صحيح على لغة.
والمختار في العربيَّة: الهادي بالياء، وقد قدَّمنا ذكر هذا في مقدِّمة الكتاب وغيرها، واللَّه أعلم. (ج/ص: 2/69)
وفيه: أبو بكر بن إسحاق واسمه: محمَّد.
وفيه: ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمَّد بن أبي مريم الجمحيِّ، أبو محمِّد المصريُّ الفقيه الجليل.
وفيه: عمرو بن أبي عمرو، عن المقبريِّ، وقد اختلف في المراد بالمقبريِّ هنا: هل هو أبو سعيد المقبريُّ أو ابنه سعيد؟ فإنَّ كلَّ واحد منهما يقال له: المقبريُّ، وإن كان المقبريُّ في الأصل هو: أبو سعيد.
فقال الحافظ أبو عليٍّ الغسانيُّ الجيانيُّ عن أبي مسعود الدِّمشقيِّ: هو أبو سعيد.
قال أبو عليٍّ: وهذا إنَّما هو في رواية إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو.
وقال الدَّارقطنيُّ: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو، عن سعيد المقبريِّ، قال الدَّارقطنيُّ: وقول سليمان بن بلال أصحّ.
قال الشَّيخ أبو عمرو بن الصَّلاح -رحمه اللَّه-: رواه أبو نعيم الأصفهانيُّ في كتابه (المخرج على صحيح مسلم) من وجوه مرضيَّة عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريِّ هكذا مبيَّناً.
لكن رويناه في (مسند أبي عوانة) المخرَّج على (صحيح مسلم) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سعيد، ومن طريق سليمان بن بلال، عن سعيد كما سبق عن الدَّارقطنيِّ، فالاعتماد عليه إذاً، هذا كلام الشَّيخ.
ويقال: المقبريُّ، بضمِّ الباء وفتحها، وجهان مشهوران فيه وهي نسبة إلى المقبرة، وفيها ثلاث لغات: ضمُّ الباء وفتحها وكسرها، والثَّالثة غريبة.
قال إبراهيم الحربيُّ وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له: المقبريُّ.
وقيل: كان منزله عند المقابر.
وقيل: إنَّ عمر بن الخطَّاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- جعله على حفر القبور، فقيل له: المقبريّ، وجعل نعيماً على إجمار المسجد، فقيل له: نعيم المجمر، واسم أبي سعيد: كيسان اللَّيثيّ المدنيّ، واللَّه أعلم. (ج/ص: 2/70)
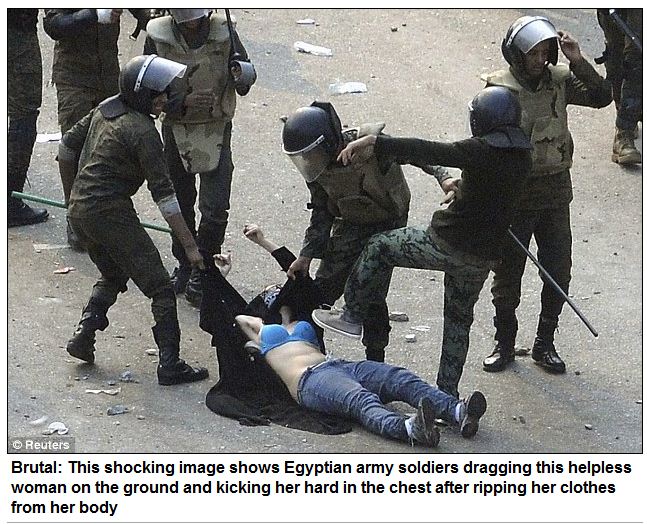
©
2012-2002, Dara O Shayda